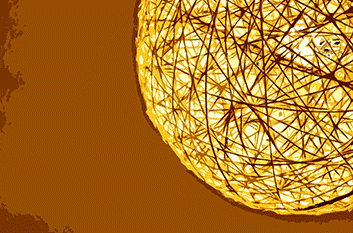بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمده ثانية أن هيأ لي هذه الفرصة الطيبة لأكون بين ثلة من العلماء والمفكرين وقادة الرأي، والشكر هنا موصول لإدارة مركز حرمون والقائمين عليه، والشكر ذاته لأسرة صالون الكواكبي على إتاحتهم الفرصة الكريمة هذه بلقاء كوكبة من رواد الفكر التنويري في عالمنا العربي للحديث في أمر يشكل رافعة لمشروع النهضة المأمول لهذه الأمة، لعله يمكن لها القوة ما يجمع صفها، ويجمع تياراتها، ويركز جهد أبنائها على اختلاف رؤاهم واتجاهاتهم الفكرية والحركية، ليكون هدفنا جميعًا حرية الإنسان وكرامته ورفاهه.
ولعل أكبر مشكلة تواجه عالمنا العربي الآن هي (كيفية الانتقال إلى نموذج الدولة المدنية الحديثة) لابل كيف تتحرر من قيود العسكر الذين قال عنهم شاكر النابلسي رحمه الله في كتابه (الدولة العسكرية في مصر وبلاد الشام) إن المستعمر قد أنشأ جيوشًا للدول الوطنية وربط هذه الجيوش به، قبل أن ينشئ إمارات وممالك وجمهوريات، وأوكل إلى هذه الجيوش إفراز الحاكم أيًا كان مسماه.
من هنا كانت عملية التنوير ضرورية وملحة، ورحم الله ابن تيمية عندما أعلنها صريحة، فقال: (إن الله لينصر الدولة العادلة الكافرة على الدولة الظالمة المسلمة).
ولما كان فقهنا السياسي السني منه والشيعي لا يستند في الحقيقة إلى أي نص قطعي يحدد شكله وآلياته، وإنما كان انعكاسًا وتجميعًا لتجارب الحكم لدى الحضارة الفارسية والبيزنطية ومن نافلة القول الاستطراد في الاستفادة من الإرث الحضاري المعاصر لتطوير مشروعنا السياسي، في إطار تعزيز الديمقراطية، وتحسين نوعية الحكم للقيام بعملية الإصلاح في الفكر والحكم والسياسة والاجتماع، ذلك أن الأنظمة التي تولت أمورنا حوالى قرن من الزمن أعادتنا قرونًا الى الوراء، واستنزفت طاقات الأمة ومجدديها في الصراع والتشويه.
إن التنوير بأشكاله كافة هو الحل لحال الاحتباس النظري والعملي التي تعانيها أمتنا، ولا بد أن تستند إلى الدين أولًا لما له من أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع، وفي تشكيل وعي الإنسان وتفجير طاقاته ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.
إن أهمية استرداد الدين من مختطفيه سواء المفرطين أم المتطرفين، ومحاربة التفسير الماضوي للدين، وربطه بالحياة، والخروج به الى فضاء الفن والثقافة والإبداع.
قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
﴿قدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
أعود وأقول إن الحركة الفكرية الإسلامية مرت بمحطات مد وجزر تبعًا لحالة الاستقرار السياسي والأمني، والانفتاح على مكونات المشهد الثقافي والفكري والإنساني جميعها، الأمر الذي أوجد تيارات فكرية تقترب من القرآن الكريم والسنة النبوية في مسائل، وتبتعد عنهما بمسائل أخرى، لدرجة أن بعضها عُدَّ خروجًا عن الفكر الإسلامي الصحيح، واتهم أتباعه بالخروج من دائرة الإيمان والإسلام.
ولعل ما شهده العصران الأموي والعباسي من انفتاح فكري عام بحكم اتساع حدود الدولة الإسلامية، وتعدد مكوناتها الشعبية ومرجعياتهم الثقافية والفكرية قد مهد لحال فكرية تسمح بتعدد الاتجاهات والمضامين الفكرية والثقافية، الأمر الذي أفرز مصطلحات واتجاهات لم يكن للإسلام والمسلمين عهد بها من قبل، ومستفيدة تلك الاتجاهات من حركة الترجمة والتأليف التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة الإسلامية.
وكان من بين التيارات الفكرية التي ظهرت المعتزلة والصوفية والباطنية وغيرها، بعضها يثري العقل ويعظمه، وبعضها يمجد الروح ويسمو بها، وبعضها يقدم المتناقضات التي لا تقدم خيرًا يذكر، فجل ما تقدمه حراك فكري يؤخذ من نتاجه ويرد.
وظل الأمر كذلك – كما ذكرنا آنفًا- بين مد وجزر حتى دخلت الأمة الإسلامية العهد العثماني، بكل ما يحمله هذا العهد من إيجابيات وسلبيات، إذ بدأ العهد العثماني في العام 1299م، واستمر إلى العام 1924م، إذ مرت المنطقة العربية والإسلامية خلال تلك المدة الزمنية بحالة من انكفاء القدرات العملية والعلمية للمسلمين، نظرًا لتكالب الأعداء على الأمة وانشغال الدولة بحروبها داخل أوروبا، وزيادة أثر المشكلات الداخلية في النهج السياسي والفكري العام للدولة، والتركيز على القلب، وإهمال الأطراف، إلا أن الانفتاح على ألبانيا ومقدونيا وصوفيا وسالونيك وبلاد البلقان معظمها، والتوجه إلى البحر الإدرياتيكي وبلغراد، واستيلائهم على رودس، ووصولهم إلى فينا، ودخولهم إلى بودابست الأمر الذي أعطى قوة لمسيرة الدعوة، وإيجاد تفاعل أكثر من أجل الاستفادة من حركة التنوير الديني التي تمثل الإسلام تمثيلًا حقيقيًا، إذ عملت على انعاش العقل الأوروبي، وحررت منهجه من التفكير المأزوم والمرعوب، ومن أوامر الكنيسة التي لا تغادر الحق الإلهي الذي يمثله رجالات الكنيسة على تفردهم بالحق المطلق الممنوح لهم من الكنيسة.
لكن التنوير الديني الذي أنعم الله به على أوروبا بفضل دخول العثمانيين إليها لم تتسع آفاقه كما يجب، وبقي محدودًا مددًا طويلة لأنه لم يترافق مع حركة تعليمية تثقيفية تنويرية تستند إلى تعليم اللغة العربية، لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ولغة الفقه والفكر، بل انحسر المد الفكري لها، وتراجع الأمر الذي ساعد في بعض الأحيان الى انتشار البدع والخرافات.
إلا أن ذلك التقهقر الفكري في منطقة ما لم يؤثر في منطقة أخرى ولو جزئيًا، الأمر الذي سمح بانبثاق الفكر التنويري الديني على أيدي دعاة مصلحين استوعبوا لغة العصر وحاجته، واستدركوا ضرورة الإصلاح الفكري لإخراج الأمة من جديد مما هي فيه من سواد الفهم وجمود الفكر.
فكان جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ورشيد رضا طليعة الحركة التنويرية التي نفضت غبار الإهمال عن الواقع الفكري، فقادوا حركة إصلاحية تصحيحية أعادت الوعي إلى مدارس البحث والتعليم برؤية تنويرية تستند إلى التجديد في الفكر الإسلامي وما يتناوله هذا الفكر.
ولعل الحركة الوهابية التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعدها بعض حركة تنويرية في نظر أتباعه ومريديه، لأنها استهدفت دعوة سلفية تدعو إلى تصحيح العقيدة الإسلامية، وتنقية التوحيد مما شابه من البدع والخرافات.
والمتابع للحركات التنويرية التي رافقت حركة التنوير الديني يلحظ نشاطًا لجمعية الاتحاد والترقي التي أرادت لتركيا نظامًا سياسيًا آخر أكثر انفتاحًا من نظام الخلافة بحسب وجهة نظرهم، وقد تغلغل وجودها في أرجاء الدولة العثمانية كافة، بوصفها حركة مناوئة لنظام الخلافة العثمانية تحت ستار التجديد والتحديث، وتكونت في البدء تحت اسم جمعية تركيا الفتاة، وكونوا خلايا سرية عدة، وانضم لهم يهود من الدونمة الذين أسهموا في الانقلاب على الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة في عام 1924م.
ومن الحركات التي أخذت على عاتقها الفكر التنويري لكن وفق معطياتها الخاصة الحركة الماسونية العالمية التي كانت وما زالت تعمل بشكل سري وتحت شعارات براقة لتحقيق العدل والمساواة والإخاء، وقد مُررت هذه الحركة برامج تغريبة مستغلة نفوذها.
أما الحركة القومية فانطلقت من المناداة بوحدة العرق واللغة والمصالح المشتركة بغض النظر عن الدين، وتعمقت هذه في أوروبا مستفيدة من الإرث الفكري الذي خلفته الثورة الفرنسية، وانتقلت إلى البلاد العربية والإسلامية في العهد العثماني، ونشأت القوميات العربية والطورانية والفرعونية والكردية والبنغالية، وبدأ تيار القومية يتأسس على شكل أحزاب سياسية، إذ أصبحت شوكة في خاصرة المجتمع الإسلامي، وهي بذلك تملأ فراغًا يتناقض مع ما جاء به الإسلام الذي يرفض القوميات وينبذها، وينادي بالوحدة والأخوة الإيمانية، واشغلت الأمة عقودًا في الحديث عن مشروع حداثي قومي يحقق الآمال، وانتهى بهزيمة فكرية وعسكرية واقتصادية شاملة.
أما حركة التنصير التي انطلقت من الغرب باتجاه البلاد الإسلامية حركة دينية سياسية استعمارية تستهدف تنصير أبناء المسلمين، وخاصة في المناطق التي يغلب عليها الجهل والفقر والمرض والتخلف، وذلك باستخدام وسائل وأساليب عدة، في الوقت الذي يقيمون فيه (أي المنصرون) مؤتمراتهم وندواتهم ومراكزهم ومعاهدهم الخاصة بهم من أجل خدمة أهدافهم وفق أعلى مستوى فكري وثقافي وتنظيمي.
وهذا الأمر سمح بوجود حركات استشراقية هدفت إلى القيام بدراسات مسحية مختلفة عن الشرق الإسلامي في مختلف الميادين: الدينية والفكرية والحضارية واللغوية والثقافية وغيرها.
وأمام هذه الحركات التنويرية المتعددة ذات المرجعيات المشبوهة التي أرادت في مجملها الشر للأمة العربية والإسلامية، فقد أدرك المثقفون والمفكرون من الدعاة المسلمين حقيقة ساطعة، وهي ضرورة إيجاد حركة تنوير ديني إصلاحي، يخلص الدعوة الإسلامية من مظاهر الجهل والجمود والتراجع، ويتيح لها الانفتاح مع الآخر وفق الضوابط الشرعية التي جاءت كدستور ثابت في التعامل مع الآخر، وفق المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة التي تستقطب العقول قبل القلوب، وتنير البصيرة قبل البصر، علمًا بأن وجود الحركات التنويرية المشبوهة تلك قد أخر وعوق انطلاق حركة التنوير الديني الإصلاحية منذ وقت مبكر الاستهداف والصراع من قبل الأنظمة، الأمر الذي حرم الأمة من نتاجات فكرية وحضارية، كان يمكن لها أن تنقذ الواقع الحضاري العربي والإسلامي منذ وقت مبكر.
مسألة التنوير الديني التي قادها البنا وأركان والنورسي والفاسي وغيرهم
إن كل حركة تجديد فكري تجابه بالرفض حينًا والقبول أحيانًا أخرى، وما بين الرفض والقبول تتأخر الفائدة ويضيع الجهد وتتشتت الفوائد، ولعل ذلك عائد الى قوى الشد العكسي لحركة التنوير الديني، إذ يرى فيها أنصار النموذج الغربي خطرًا يهدد حكمهم في إقامة دولة حداثية على أنقاض الدولة العثمانية، تستمد نفوذها وقوتها من قوى عظمى تضمن لهم البقاء والسيطرة، في الوقت الذي يرى فيه مناصرو الفكرة فائدة عظيمة، بحيث تستنهض الأمة قوتها ومقدراتها، وتنجو من كبوتها، وتستعيد حضورها الحضاري الذي تريد، حيث أفسح المجال لكثير من القوى الفكرية الوافدة للتدخل في الشأن العام الإسلامي خوفًا من وصول حركة التنوير الديني الى مفاصل الأمة جميعها، وعندها تنهض الأمة من جديد، وتستعيد هيبتها ومنعتها، ولعل ما ذكرناه آنفًا حول الدور التنويري للأمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيرهما يعد فتحًا في مسألة التنوير الديني، إذ استفادوا من بواعث اليقظة التي عاشتها مصر وخاصة بعد حملة نابليون التي أسهمت بصورة أو بأخرى في بث الوعي الفكري والعلمي نتيجة جلبها للمطبعة الى الديار المصرية.
وقد واجهت حركة التنوير الديني في العالم العربي الإسلامي تيارات معاكسة أرادت النيل من حضورها الفكري والحضاري، وكذلك عمدت الحركات الفكرية والاستعمارية الدولية إلى طرح البدائل الفكرية لتسد الفراغ الموجود في المساحة العقلية العربية والإسلامية، فعمدت إلى تشجيع ما ذكرنا سابقًا من إيجاد تيارات الماسونية العالمية، والحركات القومية، والوطنية، ذات المرجعيات المختلفة، لتشغل فكر الشباب وتبعدهم عن التركيز في أي طرح فكري إسلامي يعمل على تنظيمهم وتوحيد جهدهم وترتيب أولوياتهم، ودعم تطلعاتهم، وتحقيق آمالهم، ففشلت الحركات الفكرية، وفشلوا في الدفاع عنها أيضًا، لأنهم لا يؤمنون بحضورها الحضاري حقيقة في تاريخهم الحقيقي والفكري والوجداني، فهي تمثل فكرًا دخيلًا، كما فشلوا في تسويقها لأنهم أيضًا عاجزون عن امتلاك تلك الوسائل التي تنشرها على نطاق واسع، وتجعل منها فكرًا شموليًا للمعلم والقائد والإعلامي والفلاح والعسكري، وإنما كانت الأفكار محصورة فقط لدى خلية إدارة الحكم الفعلية التي تتصارع من أجل السلطة، فيتقدمون مرة، ويتراجعون مرات، وتصاب أفكارهم بالنكوص ، الأمر الذي جعل فكرهم محصورًا فقط في بعض أوراق جرائدهم ومذكراتهم ووسائلهم الإعلامية، ولم يفعل في الميادين الحياتية المختلفة، فتراجعوا وتراجع فكرهم.
وعندما ظهر الفكر التنويري الإصلاحي الديني، ورأت فيه السلطات الحاكمة على تنوعها بديلًا شرعيًا لها وقفت أمام هذا المد التنويري لأنها أدركت ان هذا الفكر يمثل مرجعية دينية ويحظى برعاية ربانية تنسجم والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإذا ما تم لهم ما أرادوا، أصبحوا قوة ضاربة يمكن أن تحقق للأمة ما تريد.
المحور الأول: التنوير الديني: هو القيام بإصلاح ديني، واستئناف حركة الاجتهاد لتتجاوز الفروع نحو إعادة تأصيل الأصول من خلال عمل فلسفي تأويلي كوني، وهو كذلك ترسيخ الوعي التاريخي والإيمان بالزمانية. إن التنوير هو حل ناجع لحالة الانحباس النظري والعملي التي تعانيها حضارتنا[1]
إن مسألة التنوير الديني تقتضيها عوامل عدة منها:
العامل الأول: أهمية الدين في حياة الإنسان؛ فالاعتقاد الديني بالنسبة للإنسان ضرورة نفسية للتماسك أمام صراع النزعات المتعارضة في داخله، والأقدار الواقعة عليه من الخارج؛ فالاعتقاد الديني يحصنه من الانهيار أمام صراع النزعات ومفاجآت الأقدار. وضرورة اجتماعية، لضبط علاقته بالمجتمع ذات الامتدادات المتعددة. وضرورة كونية لتفسير مصدر هذا الوجود ومآله ومعرفة سننه وقوانينه وكيفية الاستفادة منها لمصلحة الإنسان.
العامل الثاني: استنادًا للعامل السابق؛ فإن الدين عامل مهم في تشكيل وعي الإنسان، وتفجير طاقاته، التي بكل أسف وظفها الغلاة والمتطرفون والمتربصون وجهة تنافي الهدف الذي خلق من أجله الإنسان؛ ما يوجب استرداد راية الدين التي اختطفها الغلاة، وتصحيح الفهم حول الدين، وأنه عامل سلام واستقرار بنص الآية الكريمة: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}.
العامل الثالث: أهمية ربط الدين بالحياة؛ والخروج من القميص الحديدي الذي وضعه فيه المقلدون؛ فالتنوير الديني يجعل الدين فاعلًا في الساحات كلها؛ العلمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والثقافية والحضارية؛ فالرسالة الخاتمة لا يجوز حصرها في حقبة تاريخية معينة، ولا في رقعة جغرافية محصورة؛ وإنما تتحقق عالمية الإسلام بتفاعله مع قضايا الإنسان في الساحات كلها: ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين))
ولا بد بداية أن نمايز ونفصل فصلًا تامًا بين مفهوم التنوير المتعارف عليه في المجتمعات الإسلامية والمتداول في ثقافتها؛ ومفهوم التنوير في ثقافة مجتمعات الحداثة التي أسست له وتعاملت به؛ وبالذات المجتمعات الأوروبية حتى يزال الخلط الذي نشأ في أذهان الناس وتصوراتهم عن ذلك. إن مفهوم التنوير في المجتمعات الإسلامية يقع ضمن دائرة الفهم الديني؛ ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتبشير والدعوة لإله واحد. ويتلخص التنوير الديني بهذه الآية الكريمة: {قد جاءَكمُ منَ اللهِ نورٌ وكتابٌ مبين*يَهدي به الله من أتبعَ رضوانهُ سُبل السلامِ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنهِ ويهديهم إلى صراط مستقيم} [المائدة:15 -16 ] وبالطبع، إخراج الناس من الظلمات إلى النور معناه إخراجهم من الشِرك إلى التوحيد، إخراج الناس من عبودية الأصنام والآلهة المتعددة؛ إلى عبودية الله الواحد الأحد وهذا مرهون برضا الله: {ومن لمَّ يجعل اللهُ له نورًا فما لهُ من نورٍ} [النور:40 ].
إن عالمية الإسلام تؤكدها تعاليمه، وتصدقها وقائع التاريخ، واليوم نعيش عالمًا جديدًا تديره حكومة عالمية، وتعولمت كل مظاهر نشاطه، فتزداد أهمية التواصل بين الإسلام وبين الديانات والحضارات والثقافات المنتشرة في ربوع الدنيا، وذلك لاعتبارات كثيرة: فإضافة إلى موقف الإسلام المبدئي من الدعوة للتعاون بين بني البشر، فإن هنالك مصلحة حقيقية للمسلمين في التواصل الإيجابي مع الأديان والحضارات والثقافات ، فالعالم الإسلامي محتاج لنقل التكنولوجيا وتوطينها في بيئته، ومحتاج للخبرات العلمية والمعرفية في مجالات النشاط الإنساني معظمها، كما أن هنالك عددًا لا يستهان به من المسلمين يقيمون في هذه العوالم الحضارية، فإن أحسنا التعامل؛ فيمكن أن يتحول هؤلاء المسلمون إلى سفراء يبرزون الجانب الإيجابي المُغَيَّب للمسلمين، وتجدر الإشارة إلى أن تَصَدُّر الحضارة الغربية للريادة؛ حجب الرؤية عن حضارات أخرى لا تقل أهمية عن الحضارة الغربية؛ فهنالك الحضارة الصينية، والحضارة اليابانية، والهندية، والأفريقية، وغيرها من الحضارات التي يمكن أن ينفتح عليها المسلمون خاصة أنها حضارات غير ملغومة بأهداف سياسية حاجبة من الرؤية المستبصرة، وغير مشدودة لماض صراعي مع الحضارة الإسلامية يعطلها من الانفتاح والتواصل المتبادل، فالمطلوب تأكيد انحياز الإسلام لمبادئ التواصل والتعايش والتعاون مع الآخر المنصوص عليها في مراجعه الثابتة، وهذا التأكيد يكون أبلغ بالممارسة وإيجاد الآليات التي تتبناه أكثر من الكلام النظري، وهو ما يتطلب جهدًا مضنيًا يقوم بها أهل التخصص في المجالات كلها لبلورة هذا المشروع، وتنزيله لأرض الواقع. فالتنوير الديني المطلوب يتمثل في إيجاد ((تيار فكري يجمع بين الإسلام والعصر والماضي والحاضر…قادرا على أن يكون جسرا بين التيارات المتصارعة في عصرنا الحاضر وينهي القتال الدائر بين أنصار الدنيا وأنصار الدين، المتحررين والمحافظين… الإسلام المستنير إذن تيار ثقافي، واختيار فكري، وممارسة عملية لبناء الأوطان وتغيير للمجتمعات لما هو أفضل في إطار الثقافة المشتركة والعمل الوطني الموحد)).[2]
المحور الثاني: الإصلاح الفقهي : كتب عمر بنِ الخطَّاب إلى شُرَيْح: «إذا وجَدْتَ شيئًا في كتاب الله فَاقْضِ به، ولا تَلْتَفِتْ إلى غيره، وإن أتاك شيءٌ ليس في كتاب الله فاقضِ بما سنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يَسُنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاقضِ بما أجمع عليه النَّاس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنَّةِ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتكلَّم فيه أحدٌ قبلَك، فإنْ شِئْتَ أن تجتهدَ رأيَك فتقدَّم، وإن شِئت أن تتأخَّر فتأخَّر، وما أرى التَّأخُّرَ إلاَّ خيرًا لك»[3].
هذه الوصية مؤشر مفتاحي لمنهج الإصلاح الفقهي الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم جرى التَّابعون وتابعوهم لهم بإحسان على منهجِهم السَّليمِ، واقْتَفَوْا على آثارهم صراطَهم المستقيمَ، فكانوا يرجِعُون إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، فإنْ لم يجدوا في الكتابِ والسُّنَّةِ، أخذُوا بأقوالِ الصَّحابةِ، فإن لم يجدوا في ما قَالَهُ واحدٌ منهم، اجتهدوا رأيَهم.
وظل الحال كذلك حتى جاء عصر التقليد والجمود الذي أوصل الفقه إلى درجة من الركود دفعت بالعلماء إلى الدعوة للإصلاح الفقهي، والعمل على تحقيقه مستندين على الآتي:
أولًا: موضوع الإصلاح والتجديد والاجتهاد؛ ظل محل اهتمام منذ عصر الخلافة الراشدة وإلى يومنا هذا، فالقضايا التي استجدت في حياة الناس أوجبت البحث عن حلول تستنبط من المصادر الشرعية للتعامل بها، صحيح أن الموضوع يتقدم حينًا ويتراجع أحيانًا، ولكنه لم يغب عن بال أهل الشأن من العلماء الذين يرجع إليهم عامة المسلمين؛ لمعرفة حكم الشرع في القضايا التي تواجههم، ((على الرغم من شيوع فكرة إغلاق باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري وما بعده إلى عصرنا الحاضر، بين أهل السنة، من الناحية النظرية)).[4]
ثانيًا: دوافع الاجتهاد تتلخص في الحوادث التي تواجه المسلم فيسأل عنها المجتهدين، أو المتعلقة بالكليات الخمس، وترتبط بها قضايا معاصرة، من مثل تحديد النسل، وقضايا التأمين على الحياة، والقضايا التي تتعلق بالتشريع والتقنين، والموازنة بين الطرق الخاصة بالاجتهاد التي تسع المجتهدين لتحقيق الغرض من مشروعية الاجتهاد، وهو إيجاد الحلول الشرعية على ضوء الأدلة من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية.[5]
ثالثًا: الاتجاه الذي يدعو إلى الاجتهاد والإصلاح والتجديد صار غالبًا بل ملحًّا لدي عدد من العلماء الذين يعتد برأيهم.
رابعًا: مع بروز الحديث عن أهمية الاجتهاد وضرورته إلا أن الجهد المبذول لتجديد أصول الفقه ظل محدودًا، ومع محدوديته؛ فإنه يتناول الموضوع باستحياء، ونتيجة لذلك ((انفض كثير من الدارسين عن علم الأصول، وحصل لهم صدود كبير عنه لفرط صعوبته مع قلة جدواه؛ حيث لا يوجد واقع اجتهادي يناسب المادة الأصولية. وهذا بالطبع يحجب عن العلم روح النمو والتجديد التي تنشأ من تداول العقول السديدة له وكثرة المباحثات والمطارحات)).[6]
خامسًا: انبتت الصلة انبتاتًا شبه تام بين الجهد الأصولي والجهد الفقهي، وهذه قمة المأساة؛ بل إن البقية الباقية من القواعد الأصولية الدائرة في كتب الفقهاء؛ إنما يتداولها الفقهاء بينهم منذ أزمنة طويلة، وهي أحد الآثار المتخلفة عن عصور القوة؛ التي كان الأصولي فيها هو الفقيه، والفقيه هو الأصولي، فلما وجد متأخروا الفقهاء هذه القواعد في كتب أئمتهم جعلوا يتناقلونها في ما بينهم من دون رجوع إلى كتب الأصول التي هي مظانها الأصلية.[7] وطبعًا هذا هو الغالب، ومع أن هنالك محاولات لتصحيح هذا القصور إلا أنها تظل جهدًا فرديًّ لم يتبلور بعد في منهج عام يلتزمه أكثر العلماء.
المحور الثالث: الآليات؛ لكي يتحقق الإصلاح الفقهي والتنوير الديني لا بد من إنشاء معاهد متخصصة لصناعة الفقهاء باعتماد منهج ينقح التراث، ويبسط الأساليب، ويبعد من العلوم الشرعية ما ليس له علاقة بها، ويربط بين الدين والحياة، ويعتمد آليات للإصلاح تتمثل في الجوانب الآتية:
إصلاح أصول الفقه
- بما أن أصول الفقه هو العلم الذي يستند إليه الفقه، وأن الفقه يحتاج إلى تجديد كما أجمعت عليه – أو كادت – كلمة الدارسين، فلا جرم أن الأصول يحتاج إلى تجديد؛ لأن مادة الأصول في الغالب لم تكن تقصد إلى تكوين الفقيه المجتهد بقدر ما كانت تهدف إما إلى دعم المذهبية وتقرير التقليد، كما جرت عليه طريقة الأحناف – أو طريقة الفقهاء – في التأليف الأصولي؛ وإما إلى البحث الحر المرسل الذي لا يتغيا التطبيق ولا يدرج في مراقي الفقه كما سارت عليه طريقة المتكلمين في الفقه الأصولي.[8] فالإصلاح في أصول الفقه مطلوب لتجديد الفقه.
- المنهج المقترح لإعادة صياغة علم الأصول وتأليفه يستصحب معه: تعظيم الدليل النقلي، وتحري مسلك السلف في الاستنباط، ووجوب الاستدلال والبرهنة، ومراعاة قواعد الاستدلال، وبناء القواعد على الاستقراء، وبث الروح البحثية، والجمع بين الجانبين النظري والعملي، واعتبار علمي الأصول والفقه علمًا واحدًا ذا أصول وفروع، وجعل القواعد الأصولية مؤصلة لكافة أركان الدين، والحرص على الإبانة والإفهام، جعل النية والقصد والخلق أساس البحث الأصولي، وتحديد المصادر الصحيحة وحسن الاستمداد منها، واستبعاد المواد الدخيلة التي لا تحقق مقصود العلم.[9]
- بما أن العقل خصيصة إنسانية، وجعله الله شرطًا في التكليف، وحكم العقل مرجع في كثير من الأمور؛ آن الأوان لإخراجه من السجال العقيم الذي يجعله في مقابل النقل، وإحياء دوره وتوظيفه في التفكر والتدبر والاعتبار؛ على أساس أن صحيح المنقول لا يتعارض مع صحيح المعقول.
- آن الأوان للانتقال إلى الجانب العملي في الأصول والفقه؛ فالواقع تحكمه الآن أساليب الغلاة والمتطرفين، حتى كادت أن تكون هي المعتمدة في التعبير عن الإسلام، لقد وجب علينا أن ننفي عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
إصلاحُ الفقهِ بالخطوات الآتية
- من حيثُ تشجيعُ الاجتهادِ لمن تَوافرَتْ فيه شروطُه، وتحقَّقَتْ فيه أدواتُه.
- منْ حيثُ تحليتُه بالنُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، وربطُ مسائِلِه بدلائلِها، فيُذْكَرُ مع كلِّ مسألةٍ دليلُها من القرآنِ والسنَّةِ والإجماعِ والقياسِ وأقوالِ الصَّحابةِ، وغيرِها من المصادر التبعيَّة؛ وبهذا تُفْهَمُ الأحكامُ، وتُعرفُ مآخذُ الأقوالِ؛ لأنَّ أخذَ الحكم بغير معرفةِ دليله هو عينُ التَّقليدِ، وقد عرَّف العلماءُ التَّقليدَ أنَّه: «قَبُولُ قولِ الغير بغير حُجَّةٍ»، واتَّفقوا على أنَّ التَّقليدَ ليس بعلمٍ.
- من حيثُ تصفيته من الأقوالِ الشَّاذَّةِ، والآراءِ الباطلةِ المخالفةِ للنُّصوصِ، والاختياراتِ المرْجُوحَةِ التي ثَبَتَ ضعفُهَا، وإبراز المسائلِ المجمعِ عليها، والمسائلِ الرَّاجحةِ التي ثَبَتَتْ بالدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ؛ أمَّا المسائلُ التي تكافأَتْ فيها الأدِلَّةُ، ولم يُتَبَيَّنْ فيها القولُ الرَّاجحُ فَتُعْرَضُ، ويبقى الاختيارُ بحسب الرُّجوع إلى الأصل أو المرجِّحَاتِ الخارجيَّةِ، فمواردُ النِّزاعِ ومسالكُ الاجتهاد لا إنكارَ فيها.
- منْ حيثُ تصفيتُه من الفَرَضِيَّاتِ والأُغْلُوطَاتِ التي يستحيلُ وقوعُها، بل رُبَّما وصلت إلى حدِّ السَّخافاتِ والحماقاتِ ـ في بعض الأحيانِ يُسْتَحْيَى من ذكرها أو المسائلِ التي لا فائدةَ منها، ولا طائلَ من ورائِها، وقد يُعتبر البحثُ عنها من التَّكلُّفِ الذي نُهِينَا عنه، وتكون دراستُها من باب إضاعةِ الوقت وشُغْلِ البَالِ، وقد أَخْرَجَتِ الفقهَ عن مقصده وأبعدَتْه عن ميدانِ العمل.
- من حيثُ تصفيتُه من البدع والمحدثات؛ لأنَّ الأصلَ في العبادات التَّوقُّفُ، فلا يُشْرَعُ منها إلاَّ ما شَرَعَه الله وما صحَّ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.
العملُ على إخراج فقهاء مجتهدين
وتأهيلِهم لحمل الرَّايةِ، يتَّصِفُونَ بحُسْنِ الفهم، وسلامةِ الفكرِ، وقوَّةِ النَّظَرِ، ويملِكُونَ الملَكَةَ العلميَّة، تمكِّنُهم استنباط الأحكام من أدلَّتِها، وإلحاقِ ما لا نصَّ فيه بالمنْصُوصِ عليه، وذلك بتحصيل علوم الاجتهاد، كالقرآن وعلومه، والحديثِ وعلومه، وأصول الفقه وقواعدِه، والعربيَّةِ وعلومِها، ولا شكَّ في أنَّ للجامعات والكلِّيَّات الإسلاميَّةِ دورًا مهمًّا في هذا المجال.
تكوينُ طلبةِ العلمِ النُّجباءِ
وذلك للتَّفَقُّهِ بتخريج الفروع على الأصول، والتَّأَمُّلِ في مقاصد التَّشريع وأسرارِه، والنَّظرِ في معاني الأحكام ومناسباتها، واستخراجِ حكمِها وعللِها، حتى تتكوَّنَ لديهم مَلَكَةٌ علميَّةٌ، وأهليَّةٌ تامَّةٌ، وذَوْقٌ فِقْهِيٌّ سليمٌ، يمكِّنُهُم بذلك بلوغَ درجةِ «الاتِّباع»، وتمكِّنُهم من معرفة الحكم. مع الاهتمامُ بدراسة كتب الفقه المقَارَنِ، التي تُعْنَى بذكر أقوالِ الأئمَّة وأدلَّتِهِم ومآخذِهم، وتبيِّنُ القولَ الرَّاجحَ من أقوالهم، من مثل «المحلَّى» لابن حزم، و«الاستذكار» لابن عبد البَرِّ، و«المغني» لابن قدامة، و«المجموع» للنووي.
عقدُ دوراتٍ علميَّة ومَجَامِعَ فقهيَّة
تكون دوريَّةً على غِرَارِ ما هو موجود في بعض البلاد الإسلاميَّة، يلتقِي فيها العلماءُ والفقهاءُ من كلِّ أنحاء العالم، يبحثون أهمَّ القضايا المستجدَّةِ في العالم الإسلاميِّ، بغيةَ النَّظرِ فيها، ومعرفةِ حُكْمِ الشَّريعة فيها. وتشجيعُ البُحُوثِ العلميَّة التي تتناول مسائلَ فقهيَّةً معيَّنَةً، على نحو المجلاَّتِ المحكَّمة والأطروحات الجامعيَّة.[10]
أهمية الإصلاح الفكري وآلياته
كما أن إصلاح الفقه الإسلامي ليس ترفًا فكريًا أو عملًا ثانويًا، وإنما هو إجابة مباشرة على سؤال التقدم للمشروع الإسلامي، ذلك أن قيام فقهاء الأمة وعلمائها بالتجديد في القواعد والأحكام مما يتناسب مع مستجدات الأيام والأحوال؛ هو الرد العملي على تطور هذا الدين وصلاحيته الزمانية والمكانية، ذلك ان عملية التجديد توقفت منذ قرون ومن آليات التجديد الممكنة:
- العمل على تخريج وإنتاج العالم الموسوعي الذي يستوعب تطور الحياة وعلوم الشريعة من خلال معاهد متخصصة لصناعة الفقهاء باعتماد منهج منفتح على التراث ويعتمد وسائل العصر.
- إنتاج برامج دعوية وتربوية وفقهية من قبل الحركات الإسلامية تسهم في إبراز أهمية إصلاح الفقه الإسلامي وضرورته.
- العمل على تضمين جوانب الإصلاح المطلوبة لفقهنا، إذ إن فقه الأولويات والأقليات ما زال تائهًا في المدارس والمذاهب، وبين أبناء الجاليات الإسلامية، والفقه السياسي والحركي ما يزال رهن الأنظمة متكلسة الأحزاب والحركات، وفقه الحياة والمعاملات الاقتصادية والاجتماعية ما زال يراوح مكانه منذ ما قبل الدولة العثمانية إلى يومنا، وعاله على القدامى من أمثال أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم.
- ضرورة إعطاء المجامع الفقهية دورها في الانطلاق والبحث والتجديد في أصول الفقه وفي الفقه نفسه.
- العناية بدراسة الفلسفة وعلوم السياسة وفنون التحليل والاستقصاء في المعاهد والجامعات.
- تعزيز قيم الانفتاح والحرية والبعد عن الصراعات المذهبية السياسية.
- التوسع في قراءة جديدة للمذاهب والأحزاب والاتجاهات عنوانها البحث عن الجوامع المشتركة.
- تحرير مؤسسات الفتوى من براثن السلاطين ورفع الوصاية عن مؤسسات الإنتاج الفكري والفقهي (السني خاصة) والأزهر والزيتونة وغيرها أمثلة واضحة على ذلك، انتخاب الأئمة وليس تعيينهم.
- مقاومة نزعات التلقين في صياغة العقل المسلم وانتاج خطاب وسطي واقعي يكون للاجتهادات والآراء والفتاوى المعاصرة الدور الأبرز فيه يلتزم به الدعاة والمفكرون والقادة والأمراء والساسة وجهته ثوابت الأمة ومصالحها.
- العمل على مراجعة فقهنا وأحكامنا الشرعية، وخاصة ما أدخله علماء السلاطين من قواعد بدت كأنها من ثوابت الدين (حاكم مشؤوم خير من فتنه تدوم) بيعة الحكم المتغلب/ سوء فهم بعض النصوص النبوية في السمع والطاعة.
- تحرير مؤسسات الوقف وإحياؤها.
مراحل الإصلاح المطلوبة
- مراجعة التراث القديم والتخلص من الميت منه، وتصفيته من الأقوال الشاذة المخالفة للنصوص، وإبراز المسائل المجمع حولها، وكذلك البدع والسخافات والأغلوطات.
2 . اختيار العلماء المصلحين على رأس مؤسسات التعليم، فنحن لسنا بحاجة إلى دين خال من فقه الاجتهاد .
فنحن بحاجة إلى صياغة نظرية جديدة لإسلامية المعرفة مصوغة صياغة تستند إلى الفكر الحديث والقرآن الكريم وإدخالها في المنهج الدراسي الحديث لتحرير المؤسسات الدينية من أولئك الذي أوصلونا الى هذه النتيجة المرة التي نمر بها اليوم.
- 3. الانفتاح على الفلسفات والديانات والمعتقدات الأخرى، والدخول معها في حوار علمي جاد لا ديني عاطفي ميت، لأن ما طرحه الفكر الإسلامي الأول فيه الغث والسمين، وفيه الحق والباطل، وفيه الخطأ والصواب، آنئذ نثبت أننا نحن المسلمين قادرون أن نتفاعل إيجابيًّا مع الفكر الانساني كله من دون تميز، ومن ثم نخلق لنا ميزانًا في التعامل الحضاري مع الآخرين من دون خوف من سلطة أو فقيه، وهذا ما سيقودنا إلى سياسة العقل المفتوح في الإصلاح الديني المنشود.
أرى أن المطلوب اليوم هو حركة إصلاح حقيقية تنقل المبادئ والمفهومات الرئيسة للنص الديني والتاريخي إلى تشريعات حديثة مبنية على منطق الجدل العلمي للنص الديني بما يناسب حركة التطور التاريخي، لمواجهة أيديولوجية الجهاد، وفك الارتباط بين الجهاد والقتال والقتل، وبين التخريب والمتفجرات والأعمال الانتحارية المرفوضة شرعًا وقانونًا، ومقاومة الاحتلال. ومراجعة المناهج المتطرفة كلها في المعاهد الدينية المتزمتة التي يديرها التقليديون، وتفرخ لنا كل عام ألف متخلف لا يعرف من الدين والجهاد إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، والحد من المدارس الدينية الأحادية التي لا تخضع مناهجها التدريسية للمراقبة الحكومية المتوازنة، لأن ترك هؤلاء على الغارب ما هو إلا سُم زعاف تفرزه تلك الكتاتيب في مجتمعاتنا المدنية لتزيدها انغلاقًا لتحقيق مصالحها الانية السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما أنها توظف من قبل بعض الدول لتشويه الإسلام، كما نراها في العراق و باكستان ودول أخر اليوم.
وعلينا واجبًا وطنيًا ندعو منه إلى فتح نوافذ جديدة للمجتمعات المنعزلة والمنغلقة لإدخال هواء جديد لرئتها تتنفس منه، نرى أن المسلمين اليوم هم في أمس الحاجة إليه، وإلا سنبقى ندور في فلك التخلف متهمين بصفة الإرهاب والقتل من دون مراعاة لحرمة أو قانون. فالرأي بالرأي الآخر، والحجة بحجة أقوى منها، ويقول الله تعالى: {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” سورة النحل:125، ألم يفاوض الرسول الكريم (ص) قريش وثقيف قبل إسلامهما، وهو يدرك أنهما المعتديتان حتى انتصر عليهما، لأن اعتقاده أن السيفُ هو آخر الحلول.
من هنا يجب أن نقول وبكل جرأة وإقدام أن الإصلاح الديني يجب أن يبدأ من مراجعة التراث مراجعة نقدية حقيقية وقبول الأفكار الأخرى كافة حتى ولو اصطدمت بالنص الديني والسيرة النبوية الشريفة، لنتكيف ونتغير وفق الواقع الحضاري، أما لماذا فشل مشروع التنوير في محيط الفكر الإسلامي؟، على الرغم من الأحوال العسرة التي يمر بها الإنسان العربي، إلا أن اللحظة الحرجة لم تحدث بعد، لحظة السؤال الأكبر، السؤال الذي يتوجه إلى الأعماق والجذور، السؤال الخطر، بل الخطر جدًّا. حدث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر هو أكبر اصطدام للفكر الإسلامي بالحياة اليوم، وقد نتج عنه زحزحة وتحريك في العقول والأرواح في العالم الإسلامي بأسره، إلا أنها لم تصل بعد إلى المنطقة الخطرة.
فالفكر الإسلامي يعاني الانسداد التاريخي الذي يقف في وجه الأسئلة الحقيقية وعملية المراجعة الجذرية، ولكن ما سبب هذا الانسداد؟ إنه بسبب التناقض المطلق بين النص والواقع، أي بين النص وكل التطورات العلمية والسياسية والفلسفية التي جاءت بها الأزمنة الحديثة. الالتزام بحرفية النص يؤدي بالمسلم إما إلى إنكار منجزات الحداثة بل الحقد عليها وإعلان الحرب على العصر كما يفعل الظواهري وابن لادن؛ وإما إلى إنكار النص نفسه والشعور بعدئذ بالإحساس الرهيب بالخطيئة والذنب. وهكذا يقع المسلم في تناقض قاتل لا مخرج منه، والحل لن يكون إلا بالتأويل المجازي للنص والاعتراف بالمشروطية التاريخية للنص، ولا يكفي المجال هنا فهم الانسداد التاريخي الذي يعانيه العالم العربي الإسلامي اليوم لمعرفة سبب فشل الفكر التنويري في العالم الإسلامي.
[1] زهير الخويلدي، مفهوم التنوير الديني حسن حنفي نموذجا.
[2] حسن حنفي؛ الإسلام المستنير مجلة التسامح تصدر في سلطنة عمان العدد الأول
[3] زهير الخويلدي، مفهوم التنوير الديني حسن حنفي نموذجا.
[4] د.وهبة الزحيلي، تجديد الفقه الإسلامي، ص220.
[5] معالي السيد محمد أحمد الشامي، بحوث ندوة الاجتهاد في الإسلام التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان
[6] أبو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التجديد والمجددون في أصول الفقه: دراسة موسعة لجهود المجددين من علماء الأصول تنتهي إلى استخلاص منهج إصلاحي سديد، ط3، (مكتبة المسجد النبوي الشريف 1428هـ – 2007م)، ص43
[7] أبو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التجديد والمجددون في أصول الفقه، ص44
[8] أبو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التجديد والمجددون في أصول الفقه، ص66
[9] ا أبو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التجديد والمجددون في أصول الفقه، ص554 – 562 بتصرف
[10] د. عبد الحميد جمعة، مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي.