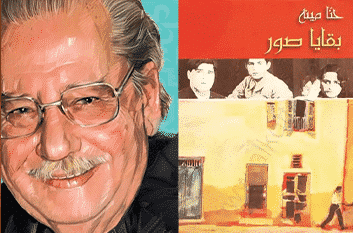أولًا: مقدمة
أشعر أنني في حاجة إلى أن أعيد قراءة هذا الكتاب، على الرغم من أنني فعلت ما يشبه ذلك، توقفت عند العديد من فقراته، وأعدت القراءة مرة، واثنتين، وثلاثًا، كيف لا وفيها ما فيها من الصور، كنت أدقق في ما ألقت عليه الضوء من معانٍ، تأثرتُ ببقايا هذه الصور كما لم أتأثر بغيرها من الكتب، وعلى الرغم من كوني وحيدًا عند قراءة هذه الصور إلا أنني شعرت بأن المراقب لملامح وجهي سيقرأ انعكاس ذلك التأثير، ترقرقت الدمعة في العين عند أكثر من مشهد، وارتسمت البسمة على الفم مع مشاهد أخرى، وخفق القلب مرات ترقبًا وانتظارًا.
ثانيًا: موضوع الرواية
أسرة سورية عاشت في عشرينيات القرن العشرين؛ أب وأم وثلاث بنات، وطفل هو أصغرهم، ومن خلال عينيه تُقرأ هذه الصور.
تبدأ الأسرة بالتنقل من البيت الذي ولد فيه الطفل في المدينة حيث خرج الأب مريضًا راقدًا على محمل، ثم غادرته الأسرة إلى مسقط رأس الوالدين حيث عاشوا أكثر من غرباء في كوخ طيني يملكه المختار، كما ملك حريتهم وحرية ابنتهم، التي رهنها مقابل وفاء الأسرة بدينها، ولم يطلقها إلا بدافع الخوف من برهوم (قريب الأم المتهم بكونه قاطع طرق مع أنه كان ينقذ المسافرين ويساعد الناس في استعادة حقوقهم).
في أثناء الإقامة في السويدية يسافر الأب كثيرًا، يرحل إلى العبث متحلِّلًا من المسؤولية، منشغلًا بالسكر منقادًا إلى الشهوة، متسربلًا بالخيبة، ويترك العائلة للعدم، خوف وترقب وجوع، وتبقى الأم صامدة في وجه المختار وقسوته.
يأتي موسم دودة القز، يولد معه الأمل ويكبر، ولكن عندما يحلّ الحرير الصناعي لا يبقى للدود مكان، فتغضب الشرانق وتطير، ويطير معها الأمل ثم يهوي فيتحطم. فلم يبق للأسرة إلا أن تلملم بقاياه وترحل إلى “الأكبر” ولم يكن هذا اسمًا للقرية التي رحلوا إليها فحسب، بل وصفًا لما واجهته الأسرة من متاعب في تلك القرية.
على الرغم من ذلك، كانت ثمة صورة من صور التعاون، صورة تظلِّلها المحبة، ويشعّ من بعض زواياها بعض الأمل، فكان أن استدام الصمود.
الأب يرحل، يتشرد، يسكر ثم يشعر بالخيبة ويندم. يقابل كل ذلك أمومة حانية، وصبر، وصمود وتدبير. كان سلوك الأب واحدًا من الشرور، يفاقم أثر الأوضاع والأحوال الأخرى مثل الإقطاع، والدرك والجراد والحرير الصناعي، والجوع والمرض فوق كل ذلك.
ثالثًا: الصور في الرواية
قال لي عنوان الكتاب إن ثمة مجموعة من الصور التي رأى الكاتب أن يتنقل بينها وصفًا لموضوع أو مجموعة من الموضوعات التي ربما كانت متصلة ومترابطة أو منفصلة، إلا أن الصفحات الأولى من الكتاب وشت أن المحتوى ليس بقايا، وإنما معرض متكامل من الصور تنقّل الراوي بينها بخفة ورشاقة، حتى انتقال السرد من أمه إلى متابعة رواية المشاهد كان سلسًا رشيقًا ومنطقيًا.
هذه صور للطبيعة غاية في الجمال، عناصرها النهر والبحر والغابة، ومعالم الشتاء من مطر وغيوم ورياح، صور للأماكن في البيت القديم وبيت السويدية الطيني في وسط الحقول والوحول، نماذج من الشخصيات ممثّلة بالأب والأم، المختار، برهوم، الإقطاعي، زنوبة وغيرهم، صور للصفات الإنسانية بتعددها، خوف، طمع، أنانية، خيبة، ظلم، وفيها أيضًا قوة، شجاعة، شهامة، تعاون، فتعالوا نتجول مع حنا مينة في هذا المعرض الغني بالصور.
صورة البيت القديم في مخيلة الطفل:
“وظلت رؤاها مزقًا، تتجمع وتتفرق، تظهر وتغيم، تتسلسل، ينقطع تسلسلها، تنقلب، تتجلس، وتمحى بفعل الزمن…….”.
وصورة بديعة للشتاء والمطر:
“مطرٌ، مطرٌ، مطر، جو رمادي والسماء على مدى البصر فضاء عبوس، كأن لا شمس بعد ولا قمر، مطر ولا شيء غير المطر……”.
وعن المطر وأحاديث الطبيعة يقول أيضًا:
“وأنا في الأصابح والأصائل أراقب المطر، أتابع وسط الوحول كيف تتشكل فقاعات الماء وتمضي وتنطفئ”.
ثم هذا المشهد لحديث الأم عن طوفان نوح حيث يتولد الأمل في أنفس الأطفال، وترتسم صورة من الترقب أبرز ما في خطوطها الخوف والأمل:
“كان نوح يتبدى لنا عجوزًا ينشر الأخشاب، ويصنع الفلك، وكنا نتخيل الحمامة وغصن الزيتون، قوس قزح فنطمئن، ثم يعاودنا القلق، فنسأل الوالدة: إذا ظل المطر أربعين يومًا يحدث الطوفان ثم نغرق جميعا؟”
- أما الوالد فكان بعيدًا عن كل ذلك، كان في عالم آخر، تحت تأثير ثالوث مصائبي. ومقابل ذلك نرى العديد من الصور للأم وهي تتحمل المسؤولية في الكثير من المواقف، مسؤولية وتضحية ومعاناة في سبيل الحياة، والأسرة، والأطفال.
- والطفولة البريئة تدرك كل ذلك، وتخاف على هذه الأم وتقلق، وتقف إلى جانبها دومًا حتى ضد الموت الذي تمثَّل للطفل برودةً في الجسم، فأخذ يجمع الحطب ليدفئ والدته اتقاء للموت.
- حفلت الرواية بالعديد من الصور للفقر، والجوع، والمرض والتشرد، وعكست معاناة الناس بشكل عام في مواجهة هذه الأحوال، وإن تناولت الأسرة بالتخصيص. وعلى الرغم من ذلك كانت ثمة نواح إيجابية في التعامل بين الناس. فالأسرة التي كانت تتلقى العون من الناس قد خصَّصت جزءًا منه للجارة العجوز في الأكبر.
- في صورة أخرى مقابلة، لم يكتف بعض البشر بقسوة الطبيعة التي جففت طباعهم، فكان أكثر ظلمًا للبعض الآخر:
“فالأزواج يظلمون زوجاتهم، والناس يظلمون بعضهم، والوكيل يظلم الناس، والمختار يظلم الوكيل والناس، حتى المختار كان يتعرض للظلم من قبل الإقطاعي الذي لم ينج من ظلم أخيه له”.
- ومع ذلك كان للطفل عالمه الخاص من الجمال الذي يستمتع به، ويتأثر به فينطبع هذا الأثر في النفس، لينعكس بعد ذلك في أكثر من موقع.
كل تلك الصور كانت تمهد للقارئ وتدفع به إلى صورة في آخر المعرض، هي نتاج طبيعي لكل ما تقدم من صور الجوع، والمرض، والفقر، والظلم، وجراد يأكل الأخضر واليابس، وأكياس تتسرب من مخزن الإقطاعي لتسد رمق أطفال جياع في هذا البيت أو ذاك، كل ذلك كان مقدمة لهذا المشهد الرائع الذي يصوِّر انتفاضة الفلاحين ضد الإقطاع:
“جاؤوا بفلاح آخر، كان مكبلًا، حافيًا، عجوزًا، وقد استجار طالبًا الرحمة لشيخوخته:
فقال الجاويش: عندما سرقت المخزن لم تكن تحسّ بالشيخوخة أو تخجل منها! أنت خبأت الحبوب في بيتك فقل لنا من جاء بهذه الحبوب؟”.
وتنطلق النيران، ليس من البنادق فحسب، بل بات المخزن كله شعلةً من نار، وزنوبة تقف في أعلاه في نوبة هيستيريا ساخرة من السيد والجاويش والحرس كأنها تقول إن لم يكن في هذا المخزن ما يسدّ رمق الجياع فالنار أولى به، وهكذا قدمت “زنوبة” نفسها فداء لأهل “الأكبر” على الرغم من سوء معاملتهم لها.
رابعًا: محاولة لفهم الرواية
كانت مجريات السرد تتّبع تفاعل أعضاء الأسرة ولا سيّما الأب والأم والطفل (الراوي) مع الأوضاع المحيطة، من نظام اقتصادي اجتماعي متداعٍ (الإقطاع)، وأحوال اجتماعية واقتصادية ترتبط بهذا النظام حيث الفقر والمرض والجهل هي سمات ذلك العصر:
- الظروف الطبيعية
مثلت هذه الظروف المشهد الخلفي لصور هذه الرواية، ففصول السنة مرت برتابة وبآثار متدرجة من سيء إلى أسوأ؛ الخوف مع الشتاء حيث لا دفء ولا غذاء، والأمل مع الربيع، والخيبة مع الصيف، والكآبة مع الخريف بصفته ملوِّحًا بويلات الشتاء الذي تبعه ربيع جاء بالرمد بدلًا من الأمل، وصولًا إلى صيف آخر قاسٍ، وهكذا. إلا أن زرقة البحر، ومياه النهر وأدغال الدفلى والشمس الحلوة كانت الجانب الآخر من صورة الظروف الطبيعية.
- شخصيات النساء
أبرز هذه الشخصيات: الأم، الزوجة المنبوذة، المرأة الأرملة، زنوبة، زوجة المختار.
أما الأم:
أتساءل هنا: هل بإمكان أحدنا تجاوز هذه الكلمة من دون أن تقفز إلى مخيلته صورة الأم التي تحدث عنها غوركي في رائعته التي تحمل الاسم نفسه؟!
بعد أن ابتُليت الأم في هذه الرواية بفقدان شقيقها، وانتقلت إلى رفقة هذا الرجل، بدأت حياة أشد قسوة بالنسبة إليها من اليتم، كان التشرد عنوانها، والجوع والمرض والآلام أبرز مفرداتها، بل هي واقع الحياة اليومية، وكانت شخصية الأب السكير المستهتر ثالثة الأثافي في قاموس أحزان هذه السيدة، فأي نوع من النساء كانت؟! لقد أدركت شخصية زوجها وفهمته جيدًا بطريقة ساعدتها في الاضطلاع بمسؤولية العائلة والحفاظ عليها في تلك الأحوال الصعبة، وقد اتخذت في سبيل ذلك سندًا وأساسًا ترتكز عليه قوامه الإيمان والصلوات، فضلًا عن تميّز شخصيتها بالمبادرة والسعي للبحث عن الحلول، إلى جانب استعانتها بالآخرين.
كانت التضحية معلمًا أساسيًا من معالم شخصيتها، ووقفت بشجاعة واستبسال ضد الجوع والمرض والفقر، ومنعت زوجها من الوقوف عند أبواب البيوت طلبًا للطعام، ورضيت لنفسها هذا الموقف.
وبحكم ما تتحلى به من بعد النظر، أدركت أنه لا بدّ أن يأتي يوم يذهب فيه الأولاد إلى مدارسهم ويتسلحوا بالعلم، ويصبحوا بمنأى من ظلم المختار، وبطش الملاك أو الإقطاعي. وقد حرصت على تعليم البنات إيمانًا منها بأن العلم سيشكِّل حماية لهنّ، وسيجنِّبهن ما تعرضت له من ذل ومهانة ومعاناة. هذه السمات الشخصية للأم سمحت لها بقيادة المركب إلى بر الأمان على الرغم من قسوة الحياة.
المرأة التي طردها زوجها:
ترى كم من النساء في العالم كله يحملن هذا اللقب عبر الأزمان، بغض النظر عن الأديان والملل والمذاهب والجغرافيا والتاريخ؟!
ولماذا خصّها حنا مينة بهذه الصفة؟ لعله أراد أن يبرز بؤس نظرة المجتمع إلى معاناة هذه المرأة التي تعزّزت مأساتها، وباتت ضحية بأكثر من شكل، معلنًا بذلك إدانته لهذا النمط من التعامل مع المرأة:
تعرضت هذه المرأة لاعتداء جنسي من مجموعة من الأشقياء، فأصبحت في نظر زوجها والمجتمع معه ومن حوله “عائبة”، وفقدت كل شيء؛ الأولاد، والبيت، والطعام، والأمن، حتى تعاطف الطفولة البريئة كان مغلفًا بضبابية الصورة واستحالتها على الفهم.
الأرملة:
بعيدًا عن “ما قيل عنها” من “نهم في اصطياد الرجال”، كانت الأرملة للأم والعائلة عونًا ومصدرًا للأمان من المخاطر بأنواعها، وقد ساهمت من خلال علاقتها بالأم والتي كانت الأم تعلمها جيدا، في منع سفر الوالد وبقائه مع العائلة ولو إلى حين. نعم كانت على علاقة بالوالد لكنها لم تستحوذ عليه، وكانت للأم صديقة وأختًا وبرَّ أمان.
زنــــــوبـــة:
كانت زنوبة زوجة، وكانت أمًّا، لكنها باتت ذات يوم لا أمًّا ولا زوجة، أرملة ثكلى استعانت بالخمر كي تنسى، فابتُليت بالإدمان عليه، وجرّ عليها وابلًا من العواقب، إذ باتت لقمة سائغة للذئاب البشرية التي لم تكن تجرؤ على مواجهتها في ساعات وعيها، لم تكن تمارس الجنس احترافًا، حتى السرجان بجبروته وسلطته لم تستسلم له طوعًا وإنما حاول ذلك اغتصابًا.
كان ذلك جانبًا من شخصية زنوبة، الجانب الظاهر للمجتمع، أو على نحو أدق هي الصورة التي ينظر إليها المجتمع بما تشكل لديه من قيم ثقافية وأخلاقية في تلك الفترة من الزمن، متعاميًا عن جوانب أخرى أهمها أنها كريمة، متسامحة، متعاونة، محبة للناس، تواقة للتعامل معهم على أساس من المودة المتبادلة، وهي فياضة بمشاعر الأمومة التي أغدقتها على الطفل (الراوي). وهي أيضًا مبادرة للقيام بواجباتها الاجتماعية، كاتمة للسر، شجاعة، وتكلَّلت مآثرها كلها بالتضحية بنفسها بحرق مخزن الحبوب.
خاف الإقطاع والدرك من صورة زنوبة، ومن مخاطر انتشار هذه الصورة فعاجلها برصاصة ألقت بجثتها أرضًا، ولكنها لم تُسقِط روحها الأبية الشامخة، مضت بوسام البطولة رغمًا عن كل الذئاب التي نهشتها في لحظات غياب وعيها وضعفها، فعن أي ضعف بعد ذلك نتحدث؟!
حتى الطفلة، وهي الزوجة والأم في المستقبل لم تنجُ من الظلم في ذلك الزمن المظلم، فأجبرت على العمل في البيوت بدلًا من الذهاب إلى المدرسة أو حتى اللعب مع الأقران، سيقت بتواطؤ الأب وضدّ رغبة الأم، للعمل لتعاني الذل والمهانة فوق ما عانت من الجوع والمرض والتشرد.
وزوجة المختار التي قد تبدو للمراقب عن بعد أنها أفضل حالًا من غيرها من النساء لم تكن في الحقيقة كذلك، فهي لا تعيش مع المختار بل تعيش ضمن أشيائه وحاجاته، تعاني كثيرًا بسبب وساوسه وتصرفاته الغريبة.
كانت المرأة إذًا مضمون هذه الرواية، وحجر الأساس فيها، وكانت عنوانًا لعدد من الصور التي قدمها المبدع حنا مينة، وهي في مجملها تشير إلى أن المرأة، على الرغم من صور معاناتها المتعددة المصادر والأشكال، وما لحق بها من ظلم، وعدوان، وقسوة، إلا أنها لم تكن لتقبل بدور الضحية بل تمرّدت وظهرت في العديد من الصور إنسانة تمارس مسؤوليتها وأمومتها في مقابل موقف بالغ السلبية للرجل، تدافع عن أطفالها ببسالة في أوضاع بالغة القسوة، وهي أيضًا الحنونة والشجاعة والمتعاونة.
وكان في صورة البطولة التي رسمتها زنوبة كمٌّ هائلٌ من الصور المتقابلة أو “المتناقضة” بين ما يعرف ويشاع عنها، وبين ما انتهت إليه من مصير عكس صورة كانت أكثر ألقًا من كل ما تقدم، وكان التناقض هنا داعمًا للفكرة الأساس ومعزِّزًا لها، بما ينسجم مع موقف الكاتب تجاه المرأة، فكان متعاطفًا ومتضامنًا ونصيرًا حقيقيًا لها، كما تجلى في العديد من أعماله اللاحقة “ناظم حكمت، السجن، المرأة، الحياة….. “.
- شخصيات الرجال
الأب:
تشير مجمل الصور التي رسمها الكاتب للأب إلى المعالم التالية لشخصيته، وهي ظاهرة في أكثر من موقع خلال السرد:
انعدام القدرة على اتخاذ القرار، فهو لم يتعود ذلك، وكان تابعًا للخال رزق، ولما حان الوقت ليكون في موقع القرار اختلّ توازنه ولم تقم لشخصيته قائمة. وأيضًا: انعدام المسؤولية، والسلبية، واللا مبالاة، والاستهتار، ثم العناد والمشاكسة وتبلّد المشاعر. والاستسلام للسكر والغرائز. ربما بدت بعض الصور مؤشرًا إلى صفات إيجابية، لكن التدقيق فيها يدلّ على تعزيز الصور السلبية.
الخـــال (رزق الله):
كانت صورة هذا الخال المتوفى تتمثل للأم في كل تصرف من تصرفات زوجها حيث تتعاظم المفارقة ويتعزّز الفقد، حتى في غياب الأب وفي ليالي وحدتها كان الخال رزق يتبدّى للأم صورة للقوة، والرجولة الحقة، والشهامة، وجاهرت كثيرًا بالتعبير عن رغبتها في انتقال هذه الصفات إلى الابن.
بـــــــــــرهــــوم:
كان برهوم الصورة الأخرى للرجولة والقوة التي استعانت بها الأم لتخليص حقها في الأرض المغتصبة، وفي تخليص ابنتها من قيد العمل في بيت المختار، ولم يكن يبالي بما كان يوصف به من كونه قاطع طرق، فقد كان في داخله يتصرف بما يمليه عليه ضميره، كان مرهوب الجانب ووظف ذلك لنفع الناس وفائدتهم.
المختار “في السويدية”:
صورة للإقطاعي بكل الصور السلبية، فلا همَّ له سوى تحصيل الأموال بغض النظر عن الجهة التي يطالبها، والفلاحون المرابعون هم هدفه، ولا يتورع عن قهرهم وتجويعهم من دون أي رادع أخلاقي أو إنساني.
السرجان (الرقيب: رتبة عسكرية):
يمثل هذا الشخص الفساد المالي والإداري المنتشر في تلك الفترة الزمنية، وما كان يقوم به من أعمال شخصية مستغلًا المركز الحكومي، حتى مساعدته للعائلة موضوع هذه الرواية جاءت على أساس صلة القرابة التي تربطهم به من ناحية، واستغلال علاقتهم بزنوبة للوصول إليها من خلالهم من ناحية أخرى.
الإقطاعي وشقيقه (قرية الأكبر):
ربما كانت العلاقة بين الإقطاعي وأخيه الأصغر، والتي تركزت بوقوف الإقطاعي في طريق أخيه وضدّ رغبته المتمثلة بمتابعة الدراسة، تشير بطريقة ما إلى العلاقة بين النظام الإقطاعي المتداعي في مواجهة الاهتمام بمتابعة التعليم بما يحمله من قيم برجوازية.