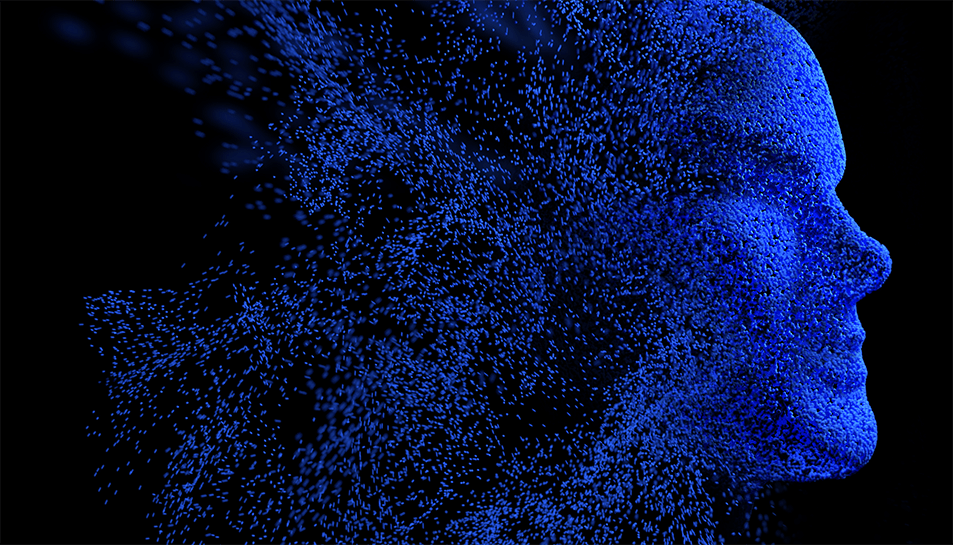كلّما عرفت أكثر عن الفيزياء، انجذبت أكثر إلى الميتافيزيقا.
ألبرت أينشتاين
لكلّ وعي ثقافي ميتافيزيقاه. تحدث جميع الثورات، سواء أكانت
في العلوم أم في تاريخ العالم، لمجرّد أن الروح قد غيّر مقولاته.
هيغل
في كتابه “اقتراب التفرّد”، الصادر عام 2005، يتنبأ عالم الحاسوب والمخترع الأميركي رايموند كورزويل بأن التطور التكنولوجي سوف يتسارع بشكل كبير في بدايات القرن الواحد والعشرين بحيث يصعب قياسه بحسب المقاييس المعروفة، وسيتمكن الذكاء الاصطناعي من استيعاب القدرات البشرية وتكريسها لحلّ المشكلات التي يعجز الذكاء البشري عن حلّها، بل وستصبح التكنولوجيا الحديثة قادرة على التعلم العميق وستتمتع بأشكال الذكاء كافة كالعاطفي والاجتماعي. وهذه كلّها تُعدّ من سمات مرحلة “التفرّد التكنولوجي” التي سنصل إليها، كما يرى كورزويل، في عام 2045 نتيجة حدوث انفجار في الذكاء الاصطناعي، سيُسبب تمزيقًا في نسيج التاريخ البشري ويؤدي إلى بلوغ مرحلة ما بعد الإنسانية.
قبل رايموند كورزويل بسنوات كثيرة، تنبأ إيرفينغ جون غود عام 1965 بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انفجار في الذكاء، فبعد تقديم نظام ذكاء اصطناعي “ذكي” بدرجة كافية، وتطوير الخوارزميات المناسبة والقادرة على التعلّم، وتجميع كمية هائلة من البيانات، ستحدث تفاعلات ضمن الدوائر، وفي لحظة معينة ستُطلَق سلسلة من ردّات الفعل التي من شأنها أن تؤدي إلى انفجار الذكاء الاصطناعي. حينئذ ستتمكن الآلات فائقة الذكاء من أن تصمِّم آلات أخرى تفوقها ذكاء، وستقترب قوة الحَوسبة من اللانهاية في فترة زمنية محدودة.
يأخذنا انفجار الذكاء، الذي يمكن أن يحدث نتيجة إفراج سريع لخوارزميات التعلّم، إلى انفجارات أخرى كالانفجار النووي الذي يحدث نتيجة إفراج سريع للطاقة، أو حتى إلى الانفجار العظيم، الذي يزعم بعض العلماء أنه يُفسِّر نشأة الكون، والذي تقول إحدى نظرياته إن الكون كان “نقطة تفرّد” ذات كثافة شديدة وحرارة عالية، ثم حدث إفراج سريع وهائل للطاقة.
كثيرًا ما وُضعَت مقارنات من هذا النوع في الآونة الأخيرة في محاولة إما للترويع من الذكاء الاصطناعي أو للترغيب فيه، إذ نجد سباقًا بين الصحف والمواقع الإلكترونية لنشر الأخبار التي تحمل عناوين من قبيل: انتحار رجل بعد أسابيع من دردشته مع روبوت الذكاء الاصطناعي، اجتماع حول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، العيش بعد الموت بفضل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يحلّ معضلة مرض السرطان.
في لحظات كهذه، حيث تختفي الحدود التي تفصل العلمي عن الخيال العلمي، المنطقي عن اللامنطقي، تصبح العودة إلى الافتراضات الميتافزيقية التي تقوم عليها الذات في علاقتها مع الذكاء ضرورة حتمية. وحدها الميتافيزيقا هنا هي القادرة على التمييز وسبر الظواهر وفهم العواقب من جهة، وإدراك طبيعة الاحتمالات الطارئة والمفاجئة التي يمكن أن تغيّر في الميتافيزيقا نفسها، من جهة أخرى. تصبح الميتافيزيقا، في لحظات كهذه، الساحة العلمية والنقدية الوحيدة. فما يُعتَقَد بأنه منفصل عن الميتافيزيقا أو عن مقولات فكرية معينة، في العلم، يتبيَّن أنه في الحقيقة قائم عليها. في هذا السياق، يكون السؤال الأول الذي يجب طرحه في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ليس سؤال الاقتصاد أو الثقافة أو الطب أو غير ذلك، بل سؤال الذات، أي علينا أن ننتقل، كما انتقلت الميتافيزيقا ما بعد كانط سابقًا، من الموضوع إلى الذات.
علام تؤسَّس ذواتنا؟ كيف تشكّلت ذاتيتنا؟ هل الذكاء جوهر الذات؟ هل الذكاء هو الذي جعلنا نصل إلى ما وصلنا إليه؟ علام يمكن أن تقوم الذات في ظلّ الذكاء الاصطناعي؟ كيف ستتشكّل؟ حين ننطلق من الذات في علاقتها مع الموضوع (الذكاء الاصطناعي)، يتبيّن لنا أن الانفجار الوحيد الذي ربما يستحق الذكر هنا ويستحق المقارنة مع انفجار الذكاء هو: انفجار الرغبة.
إن الذات التي هي نحن، التي تعي نفسها، تلك التي انتقلت من الحالة الطبيعية إلى الحالة الثقافية (أو الطبيعية-الثقافية)، وانبثقت ناطقةً بكلمة “أنا”، وانقسمت إلى وعي ولاوعي، أي تلك الذات اللغوية والثقافية والمتميّزة عن باقي الكائنات الحية، قد برزت في حيّز الوجود في البداية نتيجة انفجار في الرغبة، نتيجة إفراج سريع وهائل للرغبة.
نستطيع أن نفهم هذه الرغبة، التي نقلت الإنسان إلى عالم الثقافة، بوصفها رغبة في التمرّد على العالم الغريزي، ورغبة في التحرّر من المخطَّط الجيني الحتمي الذي يحمل برنامجًا وراثيًا ثابتًا، ويعمل بطريقة ميكانيكية، حيث يتضمَّن هذا البرنامج معلومات معينة وحاجات معينة وذكاء معينًا وقدرة معينة على التعلّم، كما يتضمَّن أيضًا حدودًا لكلّ ذلك. هذا البرنامج الوراثي “الطبيعي” يعمل أيضًا بحسب خوارزميات جينية “طبيعية” تشبه بدرجة ما خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أو للدقة، تُشبهها من حيث المبدأ.
تُفهَم هذه الرغبة في الفلسفة على أنها “فائض”. هي رغبة فائضة عن الحاجات البيولوجية المباشرة. هي رغبة تحرُّرية من الطبيعة (التحرُّر من الطبيعة لا يعني إلغاء الطبيعة وإلغاء ميكانيكيتها، بل قبول الطبيعة والتحرُّر من شيء من الميكانيكية في آن معًا). لذلك، تمثّل هذه الرغبة الحرية المغروسة في كياننا، تمثّل الفجوة ضمن المخطط الجيني التي تَنْسلّ منها حرّيتنا. وكما يقول الفيلسوف باروخ سبينوزا “الرغبة هي جوهر الإنسان”.
في محاولة لفهم تشكُّل الذات وهذه النقلة من الطبيعة إلى الثقافة، وجد كانط أن تشكُّل الذات لم يكن مباشرًا، ليست الطبيعة مسؤولة عنه وحدها، ولا الثقافة وحدها، بل هناك عنصر “بيني” مسؤول عن ذلك، وقد وصفه كانط بأنه جامح وشرس ويقف وراءه “حب كبير للحرية”. ورأى كثيرون من الفلاسفة الألمان وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني شيلينغ، الذي يُعَدّ فيلسوف الحرية بامتياز والذي وضع الحرية في قلب نَسَقه الفكري حيث لا تتعارض الحرية مع النَسَقية، أن الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة، يتطلّب حركة حرية. ففي البداية كان هناك “دوّامة بدائية عمياء” من الدوافع الوراثية الطبيعية، وكان هناك توقٌ إلى الخروج من قلب الضرورة الحتمية، فانبثقت الرغبة الجامحة التي تسعى إلى الحرية، متوسِّطة الغرائز والدوافع، لتنشأ الذات الراغِبة وتنطق “أنا”.
العملية هنا إذًا ليست بسيطة وتلقائية وحتمية وتخضع لبرنامج بيولوجي مُعَدّ سلفًا، لكنها ليست متحرّرة من البيولوجيا أيضًا. العملية ليست إيجابية (وضعية) وناعمة وسلسلة، بل تحتمل السلبية والعدائية والعنف، فالذات في انبثاقها نشأت في حركة عنيفة تطالِب بالحرية وتقاوِم فيها حتمية الطبيعة، لذلك كانت تُشبه الطفرة، تُشبه الصرخة. بكلمات أخرى، كانت الذات في حدّ ذاتها ثورة، وكل ثورة تحتمل شيئًا من العنف، ولا تُختَزَل إلى ثقافة ولا إلى طبيعة. ولأنها طفرة، ولأنها ثورة، ولأنها “جرحٌ في الطبيعة”، على حدّ تعبير هيغل، ففيها قوة مزّقت استمرارية الركود الطبيعي، وفيها سلبية عطّلت تدفق الميكانيكية الإيجابية الوضعية في التصميم الجيني (الخوارزميات الجينية الطبيعية)، ما أسماه كانط بالجموح والشراسة، وما أسماه هيغل بالسلبية، وما أسماه التحليل النفسي بدافع الموت، وهو أساس وجوهر الحرية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن دافع الموت لا يعني أن يريد المرء الموت (يختلف عن دافع الموت لدى فرويد) والسلبية لا تعني أن يكون المرء سلبيًا تجاه الحياة، بل هو ذلك البُعد البيني بين الطبيعة (الإيجابية التي تحمل برنامجًا معرفيًا وضعيًا positivitst) والثقافة (التي تحمل الإيجابية والسلبية معًا، فالثقافة تحمل الطبيعة أيضًا)، هو ذلك البُعد الذي تنبثق فيه الذات الراغِبة، وينشأ فيه سؤال الحرية.
إذًا، تنشأ الذات من حركة سلب ضد الطبيعة، فتمزّق ما هو طبيعي (تُمزِّق، لا تلغي)، هي تُمزِّق الخوارزميات الجينية بحركة سلبية، ما يفتح المجال لتدفق الرغبة الحرّة ويُدشِّن قدرة الرغبة على اختيار ما ترغب فيه. وماذا يعني سؤال الحرية بالنسبة إلى الذات الراغِبة سوى تلك القدرة على الاختيار (الخير أو الشر، الحق أو الظلم، إلخ) ما يفتح المجال أمام الأخلاق والسياسة والحياة الاجتماعية والفنية، وغير ذلك.
لذلك، نجد أن الحرية هي إمكانية الخير وإمكانية الشر. إذًا، تحمل الذات بُعدًا سلبيًا، يتيح لها الحرية، وتحمل الحرية بُعدًا سلبيًا يتيح لها اختيار الخير أو الشر. ويجدر الانتباه هنا أيضًا إلى أن السلبية ليست الشر، فهناك سلبية غير شريرة، هناك سلبية ضرورية في الحياة. ضروري جدًا التمييز بين ما هو شرير ومؤذ، وما هو سلبي وضروري للذات وحريتها (للتذكير: السلبية هي البُعد البيني بين الطبيعة والثقافة). نستطيع أن نفهم هذه السلبية الضرورية الكامنة في ذواتنا والمُعبِّرة عن حرّيتنا، والتي تقوم عليها ذاتيتنا، على أنها تلك العدائية التي تظهر لدينا حين نتعرّض لتهديد أو خطر خارجي، أو على أنها ذلك العنف الضروري الذي يظهر في الثورات، أو ذلك الإصرار المتعنّت الذي يجعلنا نحارب أو نضحّي من أجل ما نحب، أو تلك الصلابة التي تجعلنا نتخّذ قرارات سياسية ووجودية قد تؤدي إلى أذية بعض الأشياء أو الأشخاص، لكنها تنقذ أشخاصًا آخرين أيضًا. فنحن حين نختار، لا نختار بين خير واضح وشرّ واضح، ما يجعل سلبية الذات ضرورية، ولا سيّما في لحظات اتخاذ القرارات السياسية.
ولأن هناك سلبية فاعلة ضمن فعل الاختيار، فإن الذات تُدرك أن الخير يجب أن يُدرِك الشر، ويمرّ من خلاله حتى يصبح خيرًا، هذا وحده ما يجعل الفعل أصيلًا وصادقًا وحرًا في الوقت نفسه. هذه السلبية هي التي تجعل الشخص ينطق بـ “لا” في التفكير والتنظير. لا بُدَّ لكل تفكير أن يبدأ بـ “لا”. وحدها الـ “لا” السلبية قادرة على تمزيق الواقع البَدَهيّ والمباشر والانتقال إلى النقدي والعقلاني والسياسي.
هذا بالنسبة إلى تشكُّل الذات، التي هي نحن، التي تنتج من انفجار الرغبة في ذلك البُعد السلبي الذي يتيح لنا كلّ الحرية. فماذا عن انفجار الذكاء الاصطناعي؟ كيف ينعكس هذا الذكاء على تشكُّل الذات؟ نعرف أن الإنسان لم يعد يرتبط اليوم بالذكاء الاصطناعي من خلال أجهزة الكومبيوتر والأجهزة الذكية الأخرى فحسب، بل من خلال أدوات أخرى كثيرة منها شرائح “نيورالينك” مثلًا، تلك التي تُزرَع في الدماغ لتيسير التواصل بين الدماغ والكومبيوتر، والوصول إلى مرحلة الكائن السايبورغ (كائن يتألف من مكونات عضوية وغير عضوية). لم يعد هذا الكلام خيالًا علميًا، فهو يُنفَّذ الآن، وأهم وأجمل وأخطر ما فيه في الآن نفسه هو أن التكاليف المادية للشرائح والخوارزميات بسيطة جدًا، على عكس باقي الاختراعات، ما سيجعل انتشاره سريعًا وغير قابل للإيقاف. غير أننا، من خلال انفتاحنا على العالم التقني المعلوماتي وتعاطينا المستمر مع دفق المعلومات (المعلومات وليس الأفكار)، قد أصبحنا بالفعل جزءًا منه. هناك أنواع كثيرة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُطوَّر الآن، لكن جميع هذه الأنظمة تعمل، بكلمات بسيطة، من خلال الجمع بين مجموعات كبيرة من البيانات وخوارزميات المعالجة الذكية. في كلّ مرة يُجري فيها الذكاء الاصطناعي مجموعة من العمليات، فإنه يحلّل البيانات، يقيس أداءه، ويتعلّم، ويطوّر خبرة إضافية. وفي ذلك، تُشبه خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخوارزميات البيولوجية الوراثية. الميكانيكية في الحالتين هي أساس عمل الخوارزميات.
إذا نظرنا في الوعود التي يقطعها علماء الذكاء الاصطناعي على أنفسهم، فسنجد أنه يمكن تلخيصها جميعها بكلمة واحدة: “القضاء على السلبية”: القضاء على الشرّ، الجوع، المرض، الموت، التقدّم في السنّ، الاكتئاب، الحروب، الألم، إلخ. وعلى الرغم من جاذبية هذا الوعود وجماليتها، وعلى الرغم من أنها تمثّل ما نحلم به جميعًا، عالمًا يخلو من الشرور والأذى والعنف، فإنها لا تحمل في ثناياها طوباوية ذات بُعد ديني وأيديولوجي فحسب، بل الأخطر من ذلك هو أنها تحمل سلبية أشدّ وأقوى وأخطر من تلك التي يحاول الذكاء الاصطناعي القضاء عليها وطمسها.
إذا أردنا أن نربط هذا الكلام حول الذكاء الاصطناعي بتشكُّل الذات التي بدأنا منها مقالتنا هذه، فإننا نقول إنَّ القراءة الميتافيزيقية المُمكنة للذكاء الاصطناعي هي أنه محاولة تسعى إلى “لأم” جرح الطبيعة الذي تحدّثنا عنه، إلى تعبئة تلك الفجوة السلبية البينية (بين الطبيعة والثقافة)، إلى ملئها بالخوارزميات الذكية. بكلمات أخرى، هو محاولة تسعى إلى إلغاء حركة الحرية، وفائض الرغبة الذي تشكّلت منه الذات. فالذات، كي لا ننسى، تشكّلت بعد قطيعة نسبية مع البرنامج الوراثي الطبيعي الذي نحمله في داخلنا، تشكّلت نتيجة انفجار في الرغبة، طفرة مزّقت آلية عمل الخوارزميات، عطّلت الميكانيكية الجينية العمياء، فأحدَثتْ جُرحًا، أو ثُقبًا، أو فجوةً في الذات. لكن هذه الفجوة نفسها دشَّنت الحرية في كينونة الذات، افتتحت سؤال الأخلاق، وسؤال السياسة، وسؤال الفن.
وعليه، لا تكون حركة ملء الفجوة السلبية بإيجابية الذكاء الاصطناعي، على الرغم من رَونَق الذكاء الاصطناعي وجدّته وجماليته، سوى حركة عودة إلى الطبيعة، لا الطبيعة بمعناها الجميل واللطيف، بل إلى حالة من الميكانيكية العمياء وانعدام الوعي. لكن حتى هذه العودة إلى الطبيعة ليست “طبيعية” تمامًا، فالطبيعة تحتمل ما هو ميكانيكي (ولادة الخلايا وموتها) لكنها تتسع لما هو طارئ ومفاجئ وعَرَضيّ وما يجاوزها نفسها (يجاوز الخوارزميات الطبيعية، بحيث يبطلها ويحتفظ بها في الآن نفسه، كما يحدث في الطفرات وفي مستوى اللدونة العصبية)، في حين يحتمل الذكاء الاصطناعي التفاقم والتزايد (تتكاثر الخوارزميات والبيانات إلى ما لانهاية، وتشبه في ذلك خلايا السرطان التي تنمو وتتكاثر من دون توقّف).
قد يقول قائل لكننا سنكون أذكياء جدًا، أذكياء بطريقة لا يمكن حتى تصوّرها، وهنا تمامًا يجب النظر في ما يقوله العلم في الذكاء. اعتقد العلم لفترات طويلة أن الإنسان هو أكثر الكائنات ذكاءً على الأرض، لكن يدّعي علماء الأحياء التطوريون اليوم أن بعض الحيوانات قد تكون متفوقة علينا بالذكاء، لكننا لا نستطيع التعرف إلى ذكائها. ما يعني أننا نستطيع أن نضع مقاييس لنعرف مدى ذكاء الأشخاص، لكننا لا نعرف ما هو الذكاء. هل الذكاء وحده هو ما صنعنا وصنع تاريخ البشرية؟ هل نتجّه بفضل الذكاء البشري فعلًا نحو الأفضل؟ أسئلة لا تُمكن الإجابة عنها ببساطة، والأهم هو لا تُمكن الإجابة عنها بالاستناد إلى الذكاء وحده. يقول مارفن مينسكي، العالم الأميركي في مجال العلوم الإدراكية والحاسوب: لا يوجد حتى الآن نظرية مقبولة عمومًا عن الذكاء.
لكن ما يُهمنا في هذا السياق هو البُعد الذاتي والسياسي لهذه العودة إلى الميكانيكية العمياء، فشأنها شان جميع الـ “عودات” إلى الطبيعة التي غالبًا ما تنادي بها الأنظمة الشمولية والأصولية (العودة إلى الجينات والعِرق واللغة والعادات والماضي) وتقدّم وُعودًا بإلغاء الشرّ والعنف والألم في العالم، تحمل هذه العودة الطوباوية الملثَّمة بذور شرّ من نوع آخر، شرّ لن نستطيع إدراكه أو تمييزه أو معرفته، لأننا سنكون قد فقدنا ذلك البُعد السلبي الذي شكّل ذواتنا، ودشَّن حرّيتنا لنتمكن من التمييز بين الخير والشر. لا يكون طمس الفجوة السلبية هذه سوى طمس الحرية نفسها والوعي نفسه والرغبة نفسها. إن طمس الفجوة السلبية والداكنة هذه لا يعني إلا أن نعيش في عالم من الوحوش التي لا نراها ولا ندركها ولا نستطيع تمييزها فهي خارج الخوارزميات التي أصبحنا مُبَرمجين عليها. إن عالمًا لا نستطيع أن نرى فيه الشرّ ونختبر فيه الشرّ، لن يكون للخير مكان فيه. إن عالمًا لا نستطيع أن نختبر فيه الخير الذي يمرّ عبر الشرّ، لن نستطيع أن نحارب فيه الشرّ الذي يمرّ عبر الخير وينطق باسمه.
هذه المقالة تتطرّف قليلًا وتبالغ بعض الشي، لكن تطرّفها يأتي من تطرّف المقالات المعاكسة لها التي تزعم أن الذكاء الاصطناعي سيحلّ مشكلات العالم كله. ليست هذه المقالة دعوة إلى الإعراض عن الذكاء الاصطناعي، وليس غرضها الترويع منه. ولا يمكن أساسًا اختزال التطبيقات الهائلة والمهمة والضرورية جدًا للذكاء الاصطناعي في هذا الكلام الذي يبقى نظريًا ولا يمكن البتّ فيه. بالأحرى، هذه المقالة تمثّل دعوة إلى فهمه وتحديد موقعنا منه من خلال الرجوع إلى الميتافيزيقا (الميتافيزيقا لا بوصفها مجالًا ماورائيًا يحمل معطيات مجرّدة وثابتة، بل بوصفها مجالًا نقديًا يتّسع للتغيير ضمن حدود العقل والنفس والطبيعة) هي دعوة إلى أشكلة سؤال الذكاء وعدم تناوله ببداهة وبساطة، إلى عدم الاكتفاء بالتطبيقات والنتائج والمنافع، إلى عدم إهمال حقيقة أن ماهية الذكاء غير معروفة حتى الآن، إلى عدم التصديق بالذكاء وحده حلًا طوباويًا لنا ولمشكلاتنا والتعامل معه كدين جديد، هي دعوة إلى الانخراط في علومه وتطبيقاته مع إبقاء مسافة وعي ونقد منه، مع التشبّث بما لدينا من مَلَكات أخرى كالتأمل والانعكاس والخيال والحدس والحب وغير ذلك، والدفاع عنها.
لكن هنا تجدر الإشارة إلى أن أي تغيّر تقني أو ثقافي أو مناخي سيحدث في المستقبل قد لا يصيبنا جميعًا. فلا الكورونا قضت على البشرية جمعاء، ولا التغيّر المناخي الذي سيؤدي إلى نتائج كارثية سيقضي على البشرية، ولا الحروب العالمية قضت علينا جميعًا. وهذه إشارة جيدة وغير جيدة في الآن نفسه، وتفتح المجال إلى نوع آخر من فهم الذكاء الاصطناعي والتفاعل معه، وتتيح لنا إعادة النظر في مقولات الميتافيزيقا الأولى، وربما تغييرها. نحن في حالة تفاعل مستمر مع كلّ ما حولنا، ولا شك أن عالمًا يغزوه الذكاء الاصطناعي سيكون مختلفًا. يُحذِّر العلماء اليوم من حصول انقسامات شديدة بين الناس (انتهاء الرأسمالية كما نعرفها، ودخولنا في رأسمالية جديدة) لكن التاريخ بكلّ تغيّراته اتّسع دائمًا لحركات مقاومة وتحرُّر، فالحرية تنشط في اللاوعي، في ذلك البُعد السلبي من ذواتنا، الذي يجب أن نتمسّك به. تبقى هناك أسئلة كثيرة مفتوحة في هذا الموضوع، علمية وخارج نطاق العلم، لا يمكن طرقها جميعًا هنا.
إن كان هناك من “نقطة تفرّد” بشرية، كما يزعم كورزويل وغيره من العلماء، فقد حصلت منذ مئات آلاف السنين حين ذاق الإنسان الحرية، حرية إمكانية الخير وإمكانية الشر، وأدرك رغباته في نقلته الثقافية-الطبيعية، وأي نقطة أخرى مستقبلية لا تحافظ على هذه الحرية، على الرغم من إمكانية حصولها، فهي بالتأكيد ستكون “نقطة”، لكنها لن تكون نقطة تفرّد، بل قد تكون نقطة “نكوص” أو “عمى”، وإن كانت برّاقة ولمّاعة وقدّمت وعودًا جذّابة.
إن عالمًا لا يتّسع لرغبة حرّة في الحياة أو الموت، لن يكون فيه الذكاء إلا الموت نفسه.
إن عالمًا لا نستطيع أن نكون فيه أشرارًا، لن نكون فيه أخيارًا.